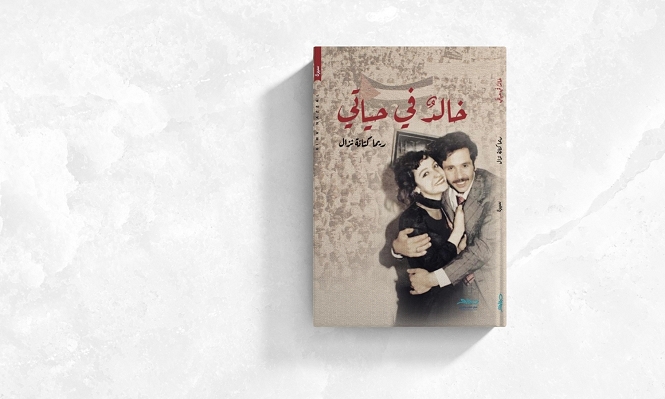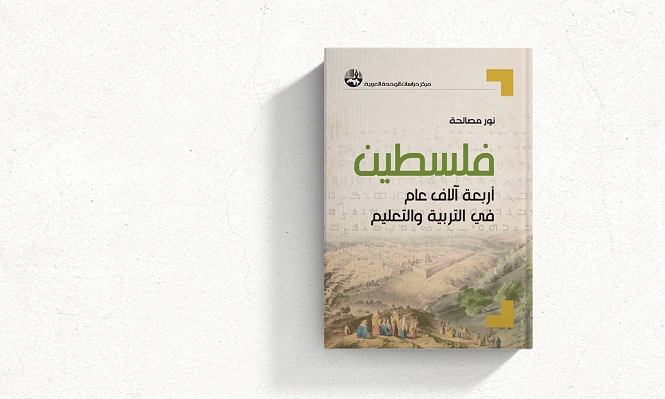سيرة حكواتي فلسطين | فصل

أصدر الفنّان والكاتب المسرحيّ الفلسطينيّ عدنان طرابشة كتابًا جديدًا بعنوان «حكاية الكاشف والمسرح والثمانية والأربعين» عن «مكتبة دار الشامل»، وجاء في 224 صفحة.
قدّم للكتاب الكاتب أنطوان شلحت، وتنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة تقديمه بإذنٍ منه.
***
يقدّم لنا عدنان طرابشة في هذا الكتاب «حكاية الكاشف والمسرح والثمانية والأربعين» (2021)، عصارة تجربة أربعين عامًا في العمل المسرحيّ، كانت مصحوبة بالصعوبات والنجاحات والفشل، كما يؤكّد، داخل صفوف الفلسطينيّين في أراضي 1948، وانطلاقًا منها ضمن المسرح الفلسطينيّ عمومًا. وليس مبالغة القول بأنّ معظم تلك الأعوام كان بمنزلة مرحلة تأسيس وبناء، لا يمكن إلّا أخذها في الاعتبار ضمن درس سيرورة التراكم، وماهيّة الصيرورة الّتي آل إليها المسرح لدينا في الوقت الراهن.
بناء على ذلك، يُعْتَبَر الكتاب بحقّ من الشهادات المهمّة على مسيرة المسرح الفلسطينيّ هنا في الداخل، وأقول ذلك من منطلق معرفتي بجوهر المساهمة الّتي قدّمها المؤلّف لهذه المسيرة، ولا ينفكّ يقدّمها، سواء ممثّلًا أو مؤلّفًا أو منتجًا لا يزال فاعلًا في صلب الحركة المسرحيّة.
فنحن نصادف كذلك اعترافات كثيرة. ولا يعيب المؤلّف وجود قدر من النزعة الفردانيّة؛ فهذه من متلازمات السيرة الذاتيّة، لأنّها تقوم في أكملها على إيمان قويّ بالأنا/ الفرد.
يغلب على كتابة طرابشة نمط السيرة الذاتيّة؛ إذ يصادفنا في صفحاته كافّة مقصد الحديث عن تجربته، بما في ذلك في الحياة العامّة، والعمليّة، والروحيّة، والسياسيّة. وبما أنّ أصول هذا الجنس من الكتابة ارتبطت، أكثر شيء، بالبوح والاعتراف، فنحن نصادف كذلك اعترافات كثيرة. ولا يعيب المؤلّف وجود قدر من النزعة الفردانيّة؛ فهذه من متلازمات السيرة الذاتيّة، لأنّها تقوم في أكملها على إيمان قويّ بالأنا/ الفرد.
يشير طرابشة إلى أنّه خلال غوصه في الذاكرة، اكتشف أنّ ما يقوم به هو عمليًّا نوع من التوثيق للحركة المسرحيّة الّتي عايشها منذ طفولته، وتأثير الاحتلال فيها من جهة، ومن جهة أخرى ما مدى إدراكه ووعيه لأهمّيّة المسرح في حياتنا الثقافيّة، واكتشف أيضًا أنّ المسرح الفلسطينيّ، كسائر الفنون، يزخر بالتجارب والإنجازات الفرديّة، ولكن، وللأسف، المشاريع الجماعيّة تُحارَب من الصهاينة، ومن الانتهازيّين المنتفعين «الشعبويّين» المتاجرين بالقضيّة الفلسطينيّة.
وإلى جانب السيرة الذاتيّة، تنهض في الكتاب سير أخرى يمكن توصيفها بأنّها «سير غيريّة»، وأعتقد أنّ أكثرها أهمّيّة سيرة «فرقة الحكواتي المسرحيّة الفلسطينيّة»، الّتي تأسّست عام 1977 في القدس المحتلّة، وكان طرابشة من مؤسّسيها، وقادت كما يقول الحركة المسرحيّة في فلسطين حقبة من الزمن، ألبستها خلالها هويّة الحكواتي الفلسطينيّ وحُلَّتَه الزاخرة بالألوان. كما نصادف سيرة المخرج الراحل رياض مصاروة، الّذي ربطت الكاتب به علاقة خاصّة شخصيّة وفنّيّة، تركت بصمتها على مسيرة المسرح الفلسطينيّ.
يسرد لنا طرابشة الكثير من التفاصيل والوقائع، الّتي تحيل في اجتماعها إلى ما هو خاصّ في تجربته الفنّيّة، بدءًا بانتقال «سوسِة» المسرح والفنّ المشهديّ عمومًا، جينيًّا أوّلًا من الأمّ ثمّ من الأب، مرورًا بفترة الطفولة والفتوّة والشباب والتعليم الجامعيّ، وانتهاءً بفسيفساء الفرق المسرحيّة الّتي انضوى تحت لوائها إلى أن أمسى بدوره «صانع فِرَق». وفي غضون ذلك لا يكفّ عن الإدلاء بمقاربته للمسرح والفنون عمومًا؛ وهي مقاربة تغذّت من الحدس أوّلًا قبل الدراسة، ثمّ من هذه الأخيرة ومن الممارسة، إنّما بدون أن تنأى عن نداء الداخل.
ونبقى في دائرة الخاصّ؛ لنشير إلى أنّ ما بدأ كاقتداء بالفطرة كان مرشّحًا للتعمّق على أساس مُمَنْهَج. ومثل هذا الحُكْم يبدو مستحقًّا؛ استنادًا إلى متابعتي لهذه التجربة منذ أعوام كثيرة. بيد أنّ المؤلّف في الكتاب يتولّى مهمّة صوغ هذا المنهج في نطاق مجموعة من التبصّرات أو الاستنتاجات الذهنيّة؛ وهي استنتاجات تتعلّق برؤيته المخصوصة لدور الحكواتي/ الممثّل، الّذي يوجزه بأنّه وعي حقيقة أنّه يؤدّي شخصيّة لها أبعادها الفكريّة؛ وهو ما يستلزم منه أن يتقمّص الشخصيّة من دون أن يتناسى هويّته، وتمتدّ لتصل إلى رؤيته حيال دور الفنّ عمومًا في المجتمعات، بما في ذلك مجتمعنا؛ وهي رؤية تنطلق من قناعة أمست راسخة بوجود علاقة جدليّة بين الروح والجسد، وبأنّ في وسع الشعوب أن تمتلك حرّيّتها إن كانت الفنون تجري في عروقها، وبأنّ الشعوب القامعة لا تُحْسِن الغناء، وبأنّه لولا الأحلام لما وُجِدَت الفنون الجميلة. ومثل هذه الاستنتاجات نعثر عليها في كلّ الكتاب، وتُسْعِف القارئ والدارس معًا في تقييم التجارب المعروض لها، أو على الأقلّ في تأطيرها.
يثير الكتاب العديد من الأسئلة والإشكاليّات المرتبطة بمسيرة المسرح الفلسطينيّ في أراضي 1948، وفي مقدّمها سؤال الهويّة، وسؤال التجدّد الجماليّ، وسؤال الجمهور، وسؤال الاستقلاليّة، وسؤال العلاقة بين المخرج والمؤلّف...
من هذا الخاصّ ينتقل المؤلّف إلى العامّ، وهنا يقدّم رؤيته حول واقع العمل المسرحيّ ومُخْرَجاتِه تحت وطأة القضيّة الفلسطينيّة عمومًا، وفي ظلّ خصوصيّة تجربة الفلسطينيّين في أراضي 1948 تحديدًا. وما يمكن قوله هنا هو أنّ طرابشة يتبنّى المقاربة الّتي ترى أنّ عمليّة تكوّن المسرح الفلسطينيّ عمومًا ارتبطت إلى حدّ كبير بالصراع مع الصهيونيّة وإسرائيل. ولا أجد أنّ ثمّة داعيًا للتوسّع في الآثار الثقافيّة- الاجتماعيّة الّتي ترتّبت على هذا الصراع، ولا سيّما ترتّبت على نكبة 1948 بالنسبة إلى الفلسطينيّين ككلٍّ، وإلى الجزء الباقي في الوطن من الشعب الفلسطينيّ، ولكن يتعيّن أن أشير إلى أنّه إذا كانت النكبة أودت بالحياة الثقافيّة في أراضي 1948 إلى هاوية سحيقة، فإنّها قضت على المسرح بينما كان لا يزال في مهده.
يثير الكتاب العديد من الأسئلة والإشكاليّات المرتبطة بمسيرة المسرح الفلسطينيّ في أراضي 1948، وفي مقدّمها سؤال الهويّة، وسؤال التجدّد الجماليّ، وسؤال الجمهور، وسؤال الاستقلاليّة، وسؤال العلاقة بين المخرج والمؤلّف، وغيرها من الأسئلة.
والحقّ أنّ هذه الأسئلة، كما يوحي الكتاب، لا تُطْرَح بوصفها استنتاجات فقط، بل أيضًا كانت ملازمة لطرابشة، ولا تزال على طول تجربته في العمل المسرحيّ، الّتي لم تقتصر على التمثيل فقط، كما سلفت الإشارة، بل تعدّتها إلى التأليف والإنتاج.
ولن أُفْسِد على القارئ والدارس متعة قراءة هذه الاستنتاجات، ولكنّني أجد أنّه لا بدّ من لفت النظر إلى أحدها، الّذي يتقاطع مع ما نعيشه ونعايشه في المرحلة الراهنة، من جوهر العلاقة بيننا كمواطنين وبين الدولة ومؤسّساتها.
يكتب طرابشة في هذا الشأن: "خلال تجربتي في مسرح ‘الكرمة‘ [تابع لمركز ’بيت الكرمة‘ في حيفا] وصلت إلى قناعة تامّة بأنّ المسرح الحرّ، الّذي أحلم به، يجب ألّا يعتمد على الدعم الحكوميّ [الإسرائيليّ] أو على مؤسّسات بلديّة وغيرها تُمَوَّل من ميزانيّات وزارة الثقافة [الإسرائيليّة]؛ فحال مسرح ‘الكرمة‘ كحال مسرح ‘الحكواتي‘ و‘نَفي تْسيدِكْ‘ [مسرح عبريّ في تل أبيب] وغيرهما، كلّها رهينة التمويل. وأنا أدمنت الحرّيّة منذ الصغر، والعربة لن تتوقّف. ولكنّ الحاجة إلى شركاء لتحقيق المسرح الآخر كانت ماسّة".
إذا كانت الحاجة إلى شركاء لتحقيق مسرح مغاير قد برّرت في الماضي التعاون مع جهات فنّيّة مموّلة حكوميًّا- و"الحاجة أمّ الاختراع" كما يقولون - فإنّها لم تَعُد كذلك بعد خوض التجربة والاكتواء بممارستها...
بكلمات أخرى، إذا كانت الحاجة إلى شركاء لتحقيق مسرح مغاير قد برّرت في الماضي التعاون مع جهات فنّيّة مموّلة حكوميًّا- و"الحاجة أمّ الاختراع" كما يقولون - فإنّها لم تَعُد كذلك بعد خوض التجربة والاكتواء بممارستها. ولا شكّ في أنّ هذا الاستنتاج يحمل الكثير من المعاني والدلالات، ويرمي إلى توصيل رسالة سياسيّة- ثقافيّة عمادها التجربة الطويلة.
وقياسًا على هذا الاستنتاج، سيصادف القارئ أنّ المؤلّف يستغرق مرّات عدّة في طرح أسئلة ناجمة عن وجود محدّد، أو عمّا وصفناها بأنّها تجربة ذات خصوصيّة، وسرعان ما ينصرف إلى الكلام السياسيّ؛ وهو ما يُوْجِب أن نطرح السؤال الآتي: هل ثمّة دور للمسرح في منأًى عن الكلام السياسيّ؟
في الكلمة الّتي ألقاها الكاتب المسرحيّ هارولد بنتر (1934 - 2008)، لدى تسلّمه «جائزة نوبل للأدب» (2005)، شدّد على ثالوث الفنّ والحقيقة والسياسة، من خلال توكيده أنّ غاية الفنّ هي البحث عن الحقيقة بأوجهها المختلفة، حتّى في تلافيف السياسة. ولا يعيب بنتر على المسرح استخدام الكلام السياسيّ. وهو يؤكّد أنّ "الكلام السياسيّ، على نحو استخدامه من طرف الساسة، لا يغامر مطلقًا في خوض المجاهل؛ لأنّ غالبيّة الساسة لا يهتمّون بالحقيقة بل بالسلطة والحفاظ عليها. ولكي يحافظوا على السلطة؛ ينبغي للناس أن يبقوا أسرى الجهل، أن يحيوا في كنف جهل الحقيقة. وإنّ ما يحيط بنا، إذن، إنّما هو نسيج رحب من الأكاذيب الّتي نتغذّى منها".
فضلًا على ذلك، في الكتاب استنتاجات أخرى تحيل إلى التقييم أو التأطير مثلما نوّهنا، ومنها الاستنتاج التالي المرتبط بفرقة «الحكواتي» منذ نشاطها الأوّل: لجأنا بعد قراءة النصّ الأوّليّ إلى مناقشة فكرة المسرحيّة من جديد، وارتجلنا حوارات جديدة معتمدين التأليف والإخراج الجماعيّ. وقد استوحينا أسلوبنا في الأداء من «الحكواتي»، الّذي روى في المقاهي والساحات الشعبيّة حكاياته، معتمدًا أسلوب التشويق. ونحن بدورنا فتّشنا عن طريقة أسميتها «البرق والرعد»، فـ "العين تُبْصِر الرعد قبل سماعه" كما قالت أمّي الكاشفة. والعين في المسرح تستوعب المضمون قبل سماع الكلمة. ولهذا؛ اعتمدنا «المسرح المرئيّ» لنصل إلى «المسرح الاحتفاليّ»، الّذي مزج بين «الكوميديا دل آرتِي» و«المسرح الملحميّ» و«الحكواتي» و«التمثيل الصامت»، وألغينا الحواجز بين الممثّل والجمهور. وفي مسرحيّة «باسم الأب والأمّ والابن» كانت البداية بصالة مضاءة، وبدّلنا الأدوار والشخصيّات أمام الجمهور، مستعملين الأقنعة وما يلزم من ملابس وإكسسوارات. وأنهينا العرض بعودتنا لشخصيّاتنا الحقيقيّة، وعدنا إلى الصالة حيث النظّارة؛ فنحن بصدد لعبة مسرحيّة نؤدّي فيها كلاعبي السيرك المشهد المطلوب، ونعود إلى مراقبة الحدث المسرحيّ على خشبة المسرح، إلى أن يحين دورنا من جديد لتقديم «نُمْرَتِنا» للمتلقّين.
وكذلك هذا الاستنتاج الّذي ضمّنه داخل رسالة كتبها إلى خطيبته، في يوم 23 نيسان (أبريل) 1980، بعد وصوله إلى فرنسا:
أبحث في المسرح عن معنًى لحياتي؛ علّني أستطيع أن أجد ضالّتي في إسعاد نفسي والآخرين. منذ أن كنت طفلًا، اعتقدت وآمنت بأنّ السعادة لا تكمن في الخرافات والأساطير، بل في مشاعر المتلقّي؛ لأنّ أمّي كانت الحكواتيّة وأنا كنت المتلقّي. ولكن عندما كبرت وأصبحت أنا الحكواتي أدركت أنّ السعادة تكمن في الحكواتي، وهو الّذي يمرّرها إلى المتلقّي؛ ولذلك على الحكواتي أن يكون على علم ودراية بمكنونات روحه قبل أن يبدأ بسرد حكاياته؛ فنجاحه مرهون باكتشاف سعادته. عليه أن يتنبّه إلى أنّ مَنْ يمتلك سحر المسرح بإمكانه أن يستخدمه في تنمية قدرات الآخرين، حسًّا وجسدًا ومعرفة.
عند الانتهاء من قراءة الكتاب، ترتسم أمامنا سيرة بهيّة لحكواتي فلسطين، الّذي نذر حياته لفنّ المسرح؛ متوخّيًا غايته الّتي حدّدها بنتر بأنّها "البحث عن الحقيقة بأوجهها المختلفة، حتّى في تلافيف السياسة".
عند الانتهاء من قراءة الكتاب، ترتسم أمامنا سيرة بهيّة لحكواتي فلسطين، الّذي نذر حياته لفنّ المسرح؛ متوخّيًا غايته الّتي حدّدها بنتر بأنّها "البحث عن الحقيقة بأوجهها المختلفة، حتّى في تلافيف السياسة".
ومثلما بدأ بسرد هذه السيرة مع أمّه، فهو يُنْهيها معها عبر إيراد وصيّتها، فيقول:
إنّ تجربة ما يزيد على أربعين عامًا في المسرح، كانت مصحوبة بالصعوبات والنجاحات والفشل. حاولتُ في سردها أن أُشْرِك مَنْ يقرؤها بحكايتي، وتخبّطاتي، وقراراتي الّتي لم أندم على واحد منها. فكما قالت أمّي الكاشفة: "مَنْ يعمل يعلم ويدرك، ومَنْ وصل مرحلة الإدراك وصل حتمًا مرحلة الوعي". أمّي الكاشفة اعتادت أن تقول لي: "لا تظنّ أنّ اللبن الرائب الشهيّ الّذي تشربه اليوم هو نفسه الّذي صنعته في البدايات. لقد أتلفت الكثير من الحليب حتّى وصلت إلى ما تشربه اليوم". أنا متأكّد أنّنا ما زلنا في مرحلة التجريب والبناء، وسنبقى إلى أن يصبح لدينا جمهور يفضّل الكتاب والمسرح على الطعام.
وهكذا في عُرْفِ المؤلّف لا معنًى للنظر إلى الوراء، إلى التاريخ، إلّا بمدى ما يتيح ذلك من إمكانيّات أمام الذات؛ لكي تحاسب ذاتها. وخلال ذلك يتكشّف طرابشة بكونه حاذقًا في اصطياد المواقف والمفارقات، الّتي تخاطب عقل المشاهد ووجدانه، من دون أن تستخفّ بذكائه.

كاتب وناقد. عمل في الصحافة لأكثر من عقدين. نشر العديد من الدراسات الأدبيّة والثقافيّة، وكذلك المتعلّقة بشؤون إسرائيليّة، سياسيّة وثقافيّة.